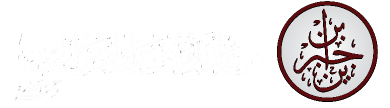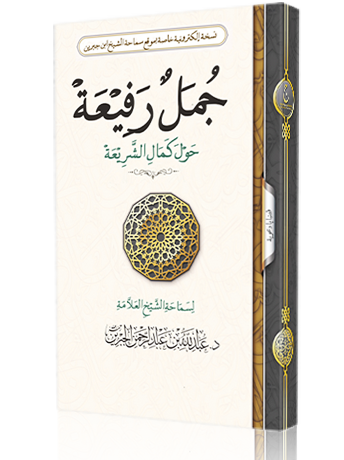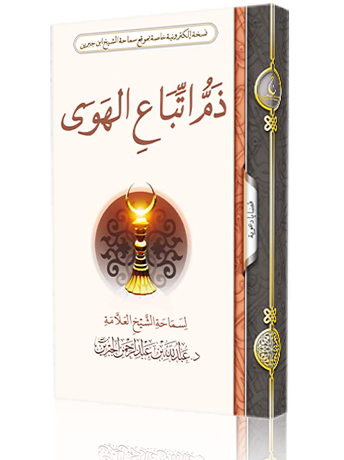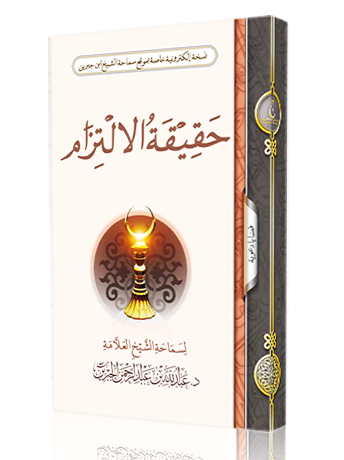جمل رفيعة حول كمال الشريعة

القرآن الكريم هدى وشفاء
وقد وصف الله كتابه المنزل على هذا النبي الكريم بأنه هدى وشفاء قال الله -تعالى-  وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ  وقال -تعالى-
وقال -تعالى-  يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ  وهذه الأوصاف الشريفة الرفيعة تقتضي أنه مشتمل على كل خير، وأن الشريعة التي اشتمل على بيانها واضحة المنهاج، كاملة في أهدافها ومقاصدها وحاجاتها، كما تقتضي من كل المخاطبين اعتناقه وتقبل كل تعاليمه، والسير على نهجه، وشدة التمسك به، رغم ما قد يحصل من عوائق أو ضيق حال أو أذى أو تعذيب في سبيل هذه الشريعة الغراء، وذلك ما عمل به الرعيل الأول وصدر هذه الأمة؛ حتى ظفروا بالمطلوب وحصلوا على خيري الدنيا والآخرة.
وهذه الأوصاف الشريفة الرفيعة تقتضي أنه مشتمل على كل خير، وأن الشريعة التي اشتمل على بيانها واضحة المنهاج، كاملة في أهدافها ومقاصدها وحاجاتها، كما تقتضي من كل المخاطبين اعتناقه وتقبل كل تعاليمه، والسير على نهجه، وشدة التمسك به، رغم ما قد يحصل من عوائق أو ضيق حال أو أذى أو تعذيب في سبيل هذه الشريعة الغراء، وذلك ما عمل به الرعيل الأول وصدر هذه الأمة؛ حتى ظفروا بالمطلوب وحصلوا على خيري الدنيا والآخرة.
وهكذا وصف الله هذا الكتاب بما يقتضي بيانه لكل شيء، وشموله لجميع الأحكام، قال الله -تعالى-  الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ
الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ  وقال -تعالى-
وقال -تعالى-  حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ
حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ  وقال -تعالى-
وقال -تعالى-  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  في آيات كثيرة يصف الله هذا القرآن بأنه مبين؛ أي: بيِّن واضح، قد بيَّن الله فيه الهدى والرشاد، وشرح فيه المناهج والأحكام، والحلال والحرام، كما يصفه بأنه نور، أي: يضئ للسالكين أحكامه، في غاية الاستنارة والسطوع، وهذه الصفات ونحوها تفيد كماله وشمول أحكامه لكل ما تمس إليه الحاجة في العبادات والمعاملات، والعقود والعهود والعقائد والأعمال، في الحال والمآل وغير ذلك.
في آيات كثيرة يصف الله هذا القرآن بأنه مبين؛ أي: بيِّن واضح، قد بيَّن الله فيه الهدى والرشاد، وشرح فيه المناهج والأحكام، والحلال والحرام، كما يصفه بأنه نور، أي: يضئ للسالكين أحكامه، في غاية الاستنارة والسطوع، وهذه الصفات ونحوها تفيد كماله وشمول أحكامه لكل ما تمس إليه الحاجة في العبادات والمعاملات، والعقود والعهود والعقائد والأعمال، في الحال والمآل وغير ذلك.
وهكذا أخبر -عز وجل- عن هذا الكتاب العظيم بأنه بيان وبصائر، كما في قوله -تعالى-  هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ  وقوله -تعالى-
وقوله -تعالى-  وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  وقوله:
وقوله:  هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ  وكذا قوله -تعالى-
وكذا قوله -تعالى-  قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ
قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ  ولا شك أن هذه الأوصاف الشريفة يفهم منها أنه بيان عام وإيضاح لحاجات الناس وأحكامهم، وبصائر تنور الطرق، وتوضح المناهج والسبل؛ ليكون الناس على بصيرة من أمرهم، وليعبدوا ربهم على نور وبرهان، وليتركوا ما كانوا فيه من الجهل العظيم والظلمات المدلهمة؛ رحمة من الله بالعباد وذكرى وموعظة لهم، وإرشادًا وتخويفًا وتحذيرًا عن التمادي في الغي، والاستمرار على ما هم فيه قبله من الضلال المبين.
ولا شك أن هذه الأوصاف الشريفة يفهم منها أنه بيان عام وإيضاح لحاجات الناس وأحكامهم، وبصائر تنور الطرق، وتوضح المناهج والسبل؛ ليكون الناس على بصيرة من أمرهم، وليعبدوا ربهم على نور وبرهان، وليتركوا ما كانوا فيه من الجهل العظيم والظلمات المدلهمة؛ رحمة من الله بالعباد وذكرى وموعظة لهم، وإرشادًا وتخويفًا وتحذيرًا عن التمادي في الغي، والاستمرار على ما هم فيه قبله من الضلال المبين.
ولا شك أن هذه الأوصاف الشريفة تدل على عمومه لحاجات الأمة نصًّا أو إشارة، وتَضَمّنه لحلّ المشكلات وإيضاح المبهمات وبيان الحق للناس في أمور دينهم ودنياهم، ضد ما يقوله الأعداء والمنافقون من تقصيره وإخلاله بالأحكام، أو تخصيصه بزمان دون زمان، أو قصره على العبادات والقربات دون العقود والمعاملات، ونحو ذلك من الأقوال السخيفة الساقطة، والظنون والأباطيل الكاذبة، والتخرصات الباطلة التي يروجها الأعداء، ومن انخدع بهم للحط من قدر هذا الكتاب المبين، وللتحرر -كما زعموا- من التقيد بعلوم الشريعة، والتصرف في حياتهم حسب الميول والأهواء، وقد نسوا أو تناسوا أن هذا القرآن الذي يعترفون بأنه تنزيل من حكيم حميد، وآية معجزة من الله -تعالى- دال على صدق هذا النبي الكريم؛ قد بيّن الله -تعالى- فيه أصول الدين وأشار إلى مسائله، وقال في حقه:  وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ  فعموم قوله -تعالى-
فعموم قوله -تعالى-  تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ
تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ  يصدق على أصول الأحكام وأسس العقائد وقواعد الدين.
يصدق على أصول الأحكام وأسس العقائد وقواعد الدين.
وهذا هو السر في وصف الدين بالكمال، قال الله -تعالى-  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا  وهذه الآية نزلت في حجة الوداع في آخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد تضمنت أن هذا الدين قد كمله الله وأتمه، وأكمل الشرائع والأدلة وسائر الأحكام؛ فقد بيّن الله في كتابه، وعلى لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- ما يلزم العباد من الطاعات والقربات؛ التي هي حقوق الله عليهم؛ فبيّن لهم أولا: أنه ربهم ومالكهم، ولفت أنظارهم إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من الآيات وعجائب المخلوقات، التي فطر الله جميع الخلق على الاعتراف بأنها صنعه وإبداعه، كقوله -عز وجل-
وهذه الآية نزلت في حجة الوداع في آخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد تضمنت أن هذا الدين قد كمله الله وأتمه، وأكمل الشرائع والأدلة وسائر الأحكام؛ فقد بيّن الله في كتابه، وعلى لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- ما يلزم العباد من الطاعات والقربات؛ التي هي حقوق الله عليهم؛ فبيّن لهم أولا: أنه ربهم ومالكهم، ولفت أنظارهم إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من الآيات وعجائب المخلوقات، التي فطر الله جميع الخلق على الاعتراف بأنها صنعه وإبداعه، كقوله -عز وجل-  أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا  الآيات، وقوله:
الآيات، وقوله:  أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا  الآيات، وقوله:
الآيات، وقوله:  أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا
أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا  الآيات، وقوله:
الآيات، وقوله:  فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا  الآيات وقوله:
الآيات وقوله:  أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ
أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ  ونحو ذلك.
ونحو ذلك.
ثم بين لهم بعد أن أقروا بأن ما في الكون كله لله، فهو الخالق المنفرد بإيجاد المخلوقات، أنه وحده المستحق لأن يفرد بالعبادة، فلا يجعل له شريك في الدعاء أو الرجاء أو التوكل أو الخضوع والركوع والسجود، أو غيرها من أنواع العبادة، بل على الخلق أن يخصوه بكل أنواع التذلل والإخبات، وأن ينيبوا إليه ويعظموه حق التعظيم؛ لأنه ربهم، وهم ملكه وعبيده، وهو المنعم عليهم المتفضل عليهم بجزيل الإنعام، فمتى صدوا عنه وأعرضوا عن عباداته فقد كفروا بربهم، وبدلوا نعمة الله كفرًا وصرفوا لغيره خالص حقه.
لذا دعا الله العباد إلى عبادته وحده لا شريك له، وكرر الأمر بذلك وأبدى وأعاد في ذلك، وضرب لهم الأمثلة، وبكَّت أولئك المشركين، وبيّن حال ما عبدوه من دون الله وأنها مخلوقة مثلهم، ولا تملك لأنفسها شيئًا فضلا عن عابديها، كما وصف نفسه -عز وجل- بصفات الكمال ونعوت الجلال التي تتضمن إحاطته بالمخلوقات، وعلمه بالأول والآخر، وسمعه وبصره المحيط بالقاصي والداني، وكل وصف يقتضي عظمته وكبرياءه وقربه من العباد، ووصف نفسه بالأولية والبقاء والدوام، والفضل والإنعام، ونحو ذلك مما يستلزم خضوع العباد له، وإنابتهم إليه، وإخلاص الدين له.